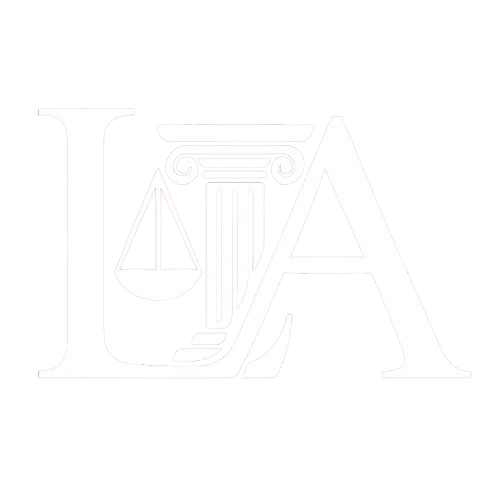العراق
منذ سقوط نظام صدام حسين، شهدت القوانين العراقية تغييرات مستمرة. فقد أصدر الحاكم المدني الأمريكي أكثر من 100 قانون ولائحة خلال عام واحد، فقد غيّر ولغى قوانين مدنية وتجارية راسخة. وفيما يلي بعض الأمثلة على التشريعات الجديدة:
عُدِّل قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997، ليمنح الشركات والأشخاص الأجانب حق تأسيس شركات عراقية وتملك أسهمها.
سُنَّت قوانين جديدة للبنوك والتأمين للسماح بالاستثمار الأجنبي والمشاركة في سوق البنوك والتأمين العراقي.
يُعد قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006، المُعدّل بالقانون رقم 2 لسنة 2010 والقانون رقم 50 لسنة 2015، تشريعًا رئيسيًا آخر يهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي في العراق. وبموجب المادة (10) من هذا القانون، تتمتع الكيانات والأشخاص الأجانب المستثمرون في العراق بنفس الحقوق والامتيازات الممنوحة للكيانات العراقية. ولهم الحق في الاستثمار وتملك الأسهم والتجارة في السوق العراقية. كما يوفر القانون ضمانات ضد المصادرة، ويضمن حرية حركة رؤوس الأموال الأجنبية. علاوة على ذلك، يجوز للمستثمرين الأجانب التمتع بحقوق وامتيازات إضافية تخضع لأي اتفاقية دولية أو ثنائية، كما هو منصوص عليه في المادة 22 من القانون.
تخضع النزاعات بين الأشخاص الطبيعيين بموجب قانون الاستثمار للقانون العراقي والاختصاص القضائي العراقي وفقًا للمادة (27)؛ إلا أن للأطراف الأجنبية حرية اختيار أي قانون واختصاص قضائي آخر، بما في ذلك التحكيم الدولي. تنص المادة (27-1) على أن "النزاعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون تخضع للقانون العراقي، ولسلطة القضاء العراقي، ويجوز الاتفاق مع المستثمر على اللجوء إلى التحكيم التجاري (المحلي أو الدولي) وفقًا لاتفاقية تُبرم بين الطرفين تُحدد إجراءات التحكيم، وسلطته، والقانون الواجب التطبيق".
على الرغم من التشريعات الجديدة، ظلّ القانون المدني العراقي الرئيسي رقم 40 لسنة 1951 وقانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، اللذان يُشكّلان عماد النظام القانوني العراقي، ساريَين دون تغيير. ويخضع قانون التحكيم لقانون المرافعات المدنية ("CCP"). وتتناول المواد من 251 إلى 276 من هذا القانون التحكيم وإجراءاته. فيما يتعلق باتفاقيات التحكيم، تنص المادة 251 من قانون المرافعات المدنية على أنه يجوز إبرام اتفاق التحكيم بشأن نزاع محدد أو قائم، وكذلك بشأن النزاعات المستقبلية التي قد تنشأ عن عقد. ويجوز إبرام اتفاق التحكيم كبند في العقد أو كعقد منفصل، باستثناء وثائق التأمين حيث يجب أن يكون اتفاق التحكيم في شكل عقد منفصل.
يجب أن يكون شرط التحكيم أو العقد مكتوبًا ومتضمنًا عناصر اتفاق صحيح. ولا يجوز إحالة النزاعات أو الخلافات القابلة للتسوية إلى التحكيم. وتنص المادة 704 من القانون المدني العراقي لعام 1951 على أن المسائل القابلة للتسوية هي تلك التي يمكن التصرف فيها بعوض ذي قيمة، ويجب أن تكون محددة أو معلومة. لا يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو الأعمال الجنائية عند وجود نزاع. إلا أن العواقب المالية أو الأضرار الناجمة عن الأعمال الجنائية أو عن الأحوال الشخصية يجوز التحكيم فيها. توضح المادة (704-1) من القانون المدني العراقي أنه "يجب أن يكون موضوع الصلح مما يجوز الأخذ به، وأن يكون محددًا إذا كان مما يجب استلامه وتسليمه". وتوضح المادة (704-2) من القانون المدني العراقي أنه "لا يجوز عقد الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو الآداب العامة، ولكن يجوز الصلح في المصالح المالية الناجمة عن الحالة الشخصية أو الناشئة عن ارتكاب جريمة".
رغم غياب النص الصريح في القانون العراقي بشأن استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي، إلا أنّ روح العدالة تميل إلى الإقرار بأن شرط التحكيم يبقى قائمًا وفاعلًا حتى لو اهتز بنيان العقد. ويستند هذا الافتراض إلى المادة (139) من القانون المدني، التي تنص على أنه في حالة بطلان أحد بنود العقد، فإن هذا البطلان لا يؤثر على بقية العقد، إلا إذا كان الشرط الباطل هو أساس الاتفاق. تنص المادة 139 على أنه "إذا كان جزء من العقد باطلاً، فإن هذا الجزء فقط يكون باطلاً ويبقى الجزء المتبقي من العقد صحيحًا ويعتبر عقدًا مستقلاً (منفصلاً) ما لم يتبين أن العقد ما كان ليتم لولا الجزء الذي تم إبطاله".
يخضع عدد المحكمين وطريقة تعيينهم لاتفاق الطرفين، على أن يكون عددهم فرديًا. إذا لم يعين أحد الطرفين محكمه، يجوز للطرف الآخر إحالة الأمر إلى المحكمة لتعيين محكم واحد أو أكثر. ويكون قرار المحكمة بتعيين المحكم نهائيًا وغير قابل للطعن. ولكن يجوز للطرف أمام المحكمة نفسها الطعن في تعيين محكم لأسباب استبعاد معينة، وطلب رد محكم سبق للمحكمة تعيينه. وهذه الأسباب الاستبعادية هي نفسها التي تنطبق على القضاة.
وفي هذا الصدد تنص المادة (93) من قانون المرافعات المدنية على أنه يجوز للمحكمة استبعاد المحكم لأسباب مثل وجود علاقة عمل، أو إذا كانت هناك صداقة أو عداوة بين المحكم/القاضي والطرف المعني، أو إذا كان المحكم/القاضي قد أبدى رأيه في القضية، أو قبل هدايا أو رشاوى.
ومن الجدير بالذكر أيضًا أن المادة 91 من قانون المرافعات المدنية قد وضعت أسبابًا أخرى لرد القاضي أو المحكم، مثل صلة الدم أو المصاهرة. كما يجب ألا يكون للمحكم أي مصلحة في النزاع، وألا يكون وكيلًا لأي من الطرفين. ويخضع قرار المحكمة برد المحكم للاستئناف كما هو منصوص عليه في المادة 261 من قانون المرافعات المدنية. وعلاوة على ذلك، يمكن اعتبار وجود مثل هذه الأسباب (للرد) سببًا لإلغاء أي قرار تحكيمي اتخذه هذا المحكم أو المحكمون المرفوضون. ووفقًا للمادة 260 من قانون المرافعات المدنية، لا يجوز للمحكم التنحي بغير عذر مقبول, ولا يمكن فصله من جانب واحد من قبل أحد الطرفين.
ومن الجدير بالذكر أن العراق طرف في عدد من اتفاقيات جامعة الدول العربية بشأن التعاون القضائي، وبروتوكول جنيف بشأن شروط التحكيم لعام 1923.
وفقًا للمادة ٢٦٥ من قانون المرافعات المدنية، يُطبّق في التحكيم المُقام في العراق قواعد الإجراءات المنصوص عليها فيه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. بمعنى آخر، لأطراف اتفاق التحكيم حرية اختيار قواعد إجرائية أخرى، مثل قواعد التحكيم الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال). كما يجوز للأطراف الاتفاق على استبعاد قواعد الإجراءات غير الإلزامية الواردة في قانون الإجراءات المدنية، وتطبيق قواعد أخرى، شريطة ألا تكون هذه القواعد مُخالفة للنظام العام والآداب العامة.
فيما يتعلق بالقانون الموضوعي، يتعين على المحكّم تطبيق القانون الواجب التطبيق على العقد المعني. في العقود العراقية بين طرفين عراقيين، أو في العقود الخاضعة للشروط العامة النموذجية الحكومية، يُطبّق القانون العراقي على النزاع. ولكن، يُطرح السؤال حول إمكانية تطبيق قانون أجنبي على التحكيم الذي يتم في العراق. نجد الإجابة في أحكام المادة (25) من القانون المدني، التي تنص على:
"1. يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فیھا الموطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطنا، فإذا اختلفا يسري قانون الدولة التي تم فیھا العقد، ھذا ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف ان قانوناً آخر يراد تطبیقه."
ومن ذلك يتبين أنه في العقد الذي يكون موطن أحد الطرفين على الأقل خارج العراق يجوز للطرفين اختيار قانون غير القانون العراقي بشرط ألا يكون تطبيق هذا القانون الأجنبي مخالفاً للنظام أو الآداب العامة.
وفقًا للمادة (٢٦٢) من قانون المرافعات المدنية، يجب على هيئة التحكيم إصدار قرارها خلال مدة محددة، إذا كانت هذه المدة محددة في اتفاق التحكيم. في حال عدم وجود مدة محددة، يجب على المحكمين إصدار قرارهم خلال ستة أشهر من تاريخ قبولهم العمل كمحكمين.
طبقًا للمادتين (268) و(269) من قانون المرافعات المدنية، لا يملك محكمو المحاكم المدنية سلطة الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة، وليس لديهم اختصاص في المسائل ذات الطبيعة الجنائية مثل التزوير والجرائم الأخرى، كما لا يملكون اختصاص الأمر بإقامة دعوى ضد الشهود الذين يتخلفون عن الحضور أمامهم.
فيما يتعلق بتنفيذ حكم التحكيم، نادرًا ما ينفذه الأطراف طواعيةً، إذ غالبًا ما يكون أحد الطرفين غير راضٍ عنه أو يرغب في كسب الوقت. ولا ينفذ قرار المحكمين لدى دوائر التنفيذ سواء كان تعيينهم قضاء أو اتفاقا ما لم تصادق عليه المحكمة المختصة بالنزاع، وفقًا للمادة (272) من قانون المرافعات المدنية. وعادةً ما تُخضع المحكمة الحكم لفحص دقيق ومفصل من حيث الشكل والقانون.
وعليه؛ يُشترط تصديق المحكمة المختصة على حكم التحكيم لإنفاذه, فإذا أيدت المحكمة الحكم، يصبح نهائيًا وقابلًا للتنفيذ، مكتسبًا قوة الأمر المقضي. ووفقًا للمادة (270) من قانون المرافعات المدنية، يجب أن يصدر حكم التحكيم إما بأغلبية الأصوات أو بالإجماع في حالة وجود أكثر من محكم واحد، ويجب أن يكون مكتوبًا وفي شكل حكم قضائي يتضمن الإشارة إلى اتفاق التحكيم، وبيان الأطراف، والأدلة المستندية، ومكان وتاريخ صدور الحكم، بالإضافة إلى أسبابه وأساسه.
ويكون للمحكمة، وفقًا لأحكام المادة (274) من قانون المرافعات المدنية، إما الموافقة على قرار التحكيم أو رفضه كليًا أو جزئيًا. وفي هذه الحالة الأخيرة، يجوز لها إعادة الأمر إلى المحكم لتصحيح الجزء المرفوض من القرار أو إصدار قرار جديد. كما يجوز لها أن تقرر الفصل في القضية بنفسها. ويجوز الطعن في قرار المحكمة المذكور، بتأييد أو رفض قرار التحكيم أمام محكمة أعلى وفقًا لقواعد الاستئناف في قانون المرافعات المدنية. وبالطبع فإن أن هذا سبب آخر للتأخير، ومن شأنه أن يُفسد الغرض المقصود من التحكيم.
حددت المادة (273) من قانون الإجراءات المدنية عددًا من الأسباب التي يجوز للأطراف بناءً عليها طلب الإلغاء من المحكمة أو التي يجوز للمحكمة بناءً عليها إلغاء الحكم من تلقاء نفسها:
أسباب الإلغاء واسعة، ويمكن تلخيصها على النحو التالي:
بطلان اتفاق التحكيم.
تجاوز المحكمون نطاق اختصاصهم.
عدم وجود أدلة مستندية معينة.
مخالفة القرار للنظام العام أو الآداب العامة. (لا يوجد تعريف شامل للنظام العام، ولكن المادة (130-2) من القانون المدني العراقي تشير إلى بعض المسائل على سبيل المثال كمسائل تتعلق بالنظام العام. كما أن القانون العراقي لا يميز بين النظام العام الوطني والدولي).
إذا وقع خطأ جوهري في القرار أو في الاجراءات التي تؤثر في صحة القرار .
إذا لم يلتزم المحكمون ببعض القواعد الإلزامية لإجراءات قانون المرافعات المدنية.
إذا كان هناك أي سبب يبرر إعادة النظر في القضية، كوجود أدلة مزورة، و
إذا كان هناك سبب يدفع أحد الأطراف للطعن في كفاءة المحكمين، كعدم حيادهم، كما سبق ذكره.
في الولايات القضائية المتقدمة، يُفسر النظام العام الدولي تفسيرًا ضيقًا. في العراق، تتمتع المحكمة المختصة بسلطة واسعة للتدخل في إجراءات التحكيم؛ فلا يكون التحكيم نهائيًا إلا بموافقة المحكمة. هناك أسباب كثيرة تدفع المحكمة إلى إلغاء قرار التحكيم وحتى الفصل في القضية بنفسها وإدخال جوهر النزاع, وهذا بلا شك تدخل غير ضروري من المحاكم في إجراءات التحكيم. يمكن القول باختصار إن الغاية من التحكيم، باعتباره وسيلة فعّالة وسريعة نسبيًا لتسوية المنازعات، لا تتحقق في النظام القانوني العراقي. إذ لا يوجد تشريع خاص ينظم التحكيم الدولي، كما لا يوجد نص قانوني يحظره صراحة. ورغم أن القضاء العراقي على دراية بمفهوم التحكيم التجاري الدولي، إلا أنه لا يقدّم الدعم اللازم للنصوص أو الممارسات المرتبطة به، مما يجعل تطبيقه في العراق محدودًا وغير مشجَّع.
كان الموقف الرسمي في العراق خلال الفترة من عام ١٩٧٠ إلى عام ١٩٨٠ هو رفض قبول بنود التحكيم الدولي في عقود المشاريع والإمدادات الحكومية، بدعوى أنها تُشكل انتهاكًا للمجال العام والاختصاص القضائي للمحاكم العراقية، وتتعارض مع مبدأ السيادة. ومع التطور الاقتصادي في العراق، ازداد اللجوء إلى التحكيم الدولي، وأُدرج في العديد من العقود المبرمة بين الشركات الأجنبية والجهات الحكومية العراقية.
وفي هذا الصدد، من المناسب أن نلاحظ أن كلا من الشروط القياسية للعقود الحكومية العراقية، وهي الشروط العامة لعقود أعمال الهندسة المدنية والشروط العامة لعقود العمليات الكهربائية والميكانيكية، قد وضعت أحكاماً خاصة لحل النزاعات، والتي بموجبها يتم إحالة النزاعات بين الأطراف إلى التحكيم الوطني وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية.
وفقًا للبند (69) من الشروط العامة لعقود أعمال الهندسة المدنية، "للجنة التحكيم كامل الصلاحية في فتح باب المراجعة ومراجعة أي قرار أو رأي أو توجيه أو شهادة أو تقييم للمهندس. ويكون قرار لجنة التحكيم ملزمًا ما لم يشترط أحد الطرفين إبطاله وفقًا للأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية".
العراق ليس طرفاً في اتفاقية نيويورك لعام 1958، ولكنه صادق على اتفاقية الرياض لجامعة الدول العربية للتعاون القضائي، والتي تتضمن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الصادرة في الدول الأعضاء.
وأخيرًا، هناك حاجة ماسة إلى قانون تحكيم جديد ومُحدّث في العراق يُغطي التحكيم الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية. وفي الوقت نفسه، وكما ذُكر سابقًا، يُخوّل قانون الاستثمار الجديد رقم 13 لعام 2006 للمستثمرين الأجانب اختيار التحكيم الدولي أو أي جهة قضائية أجنبية لتسوية النزاعات.